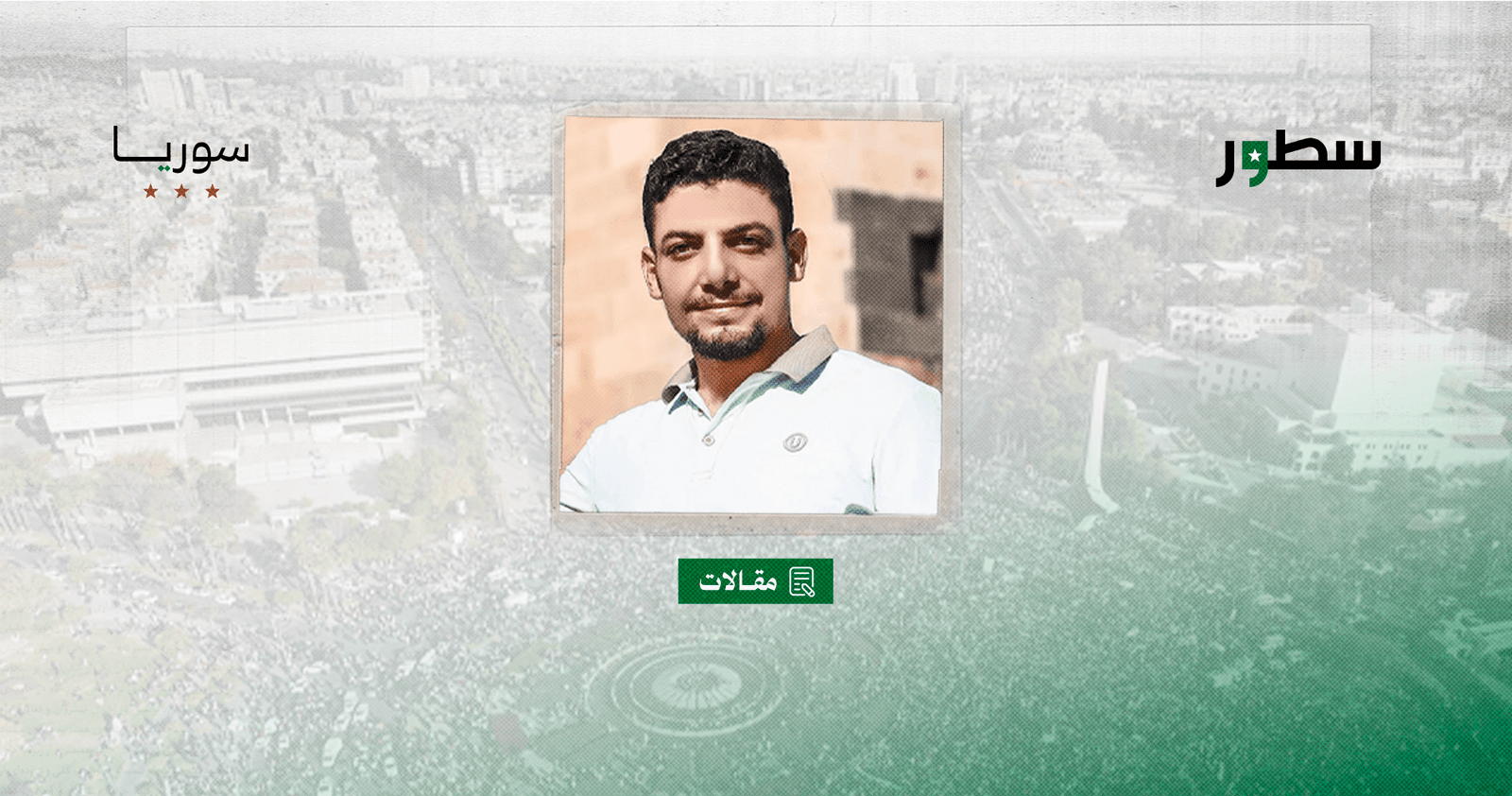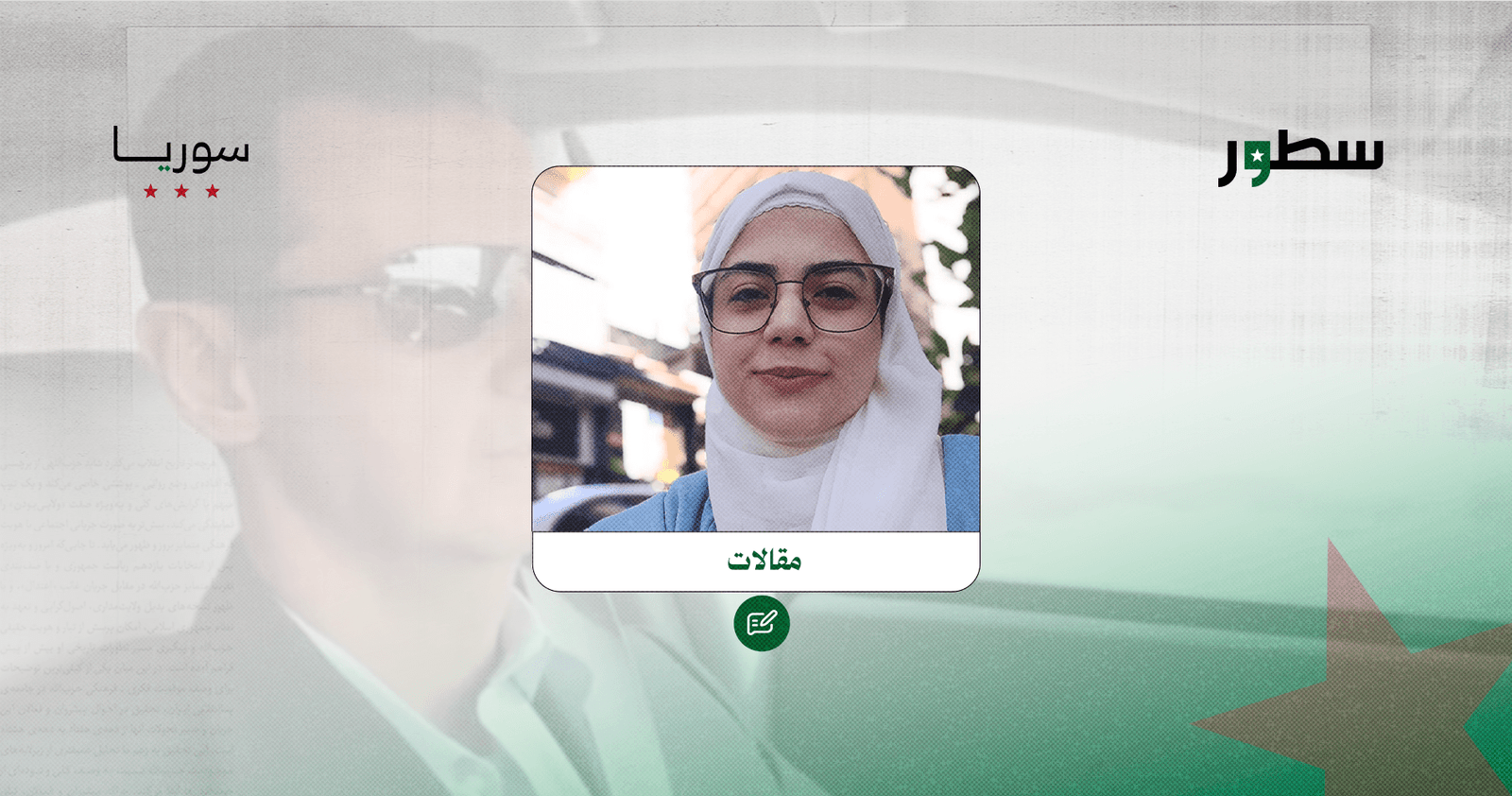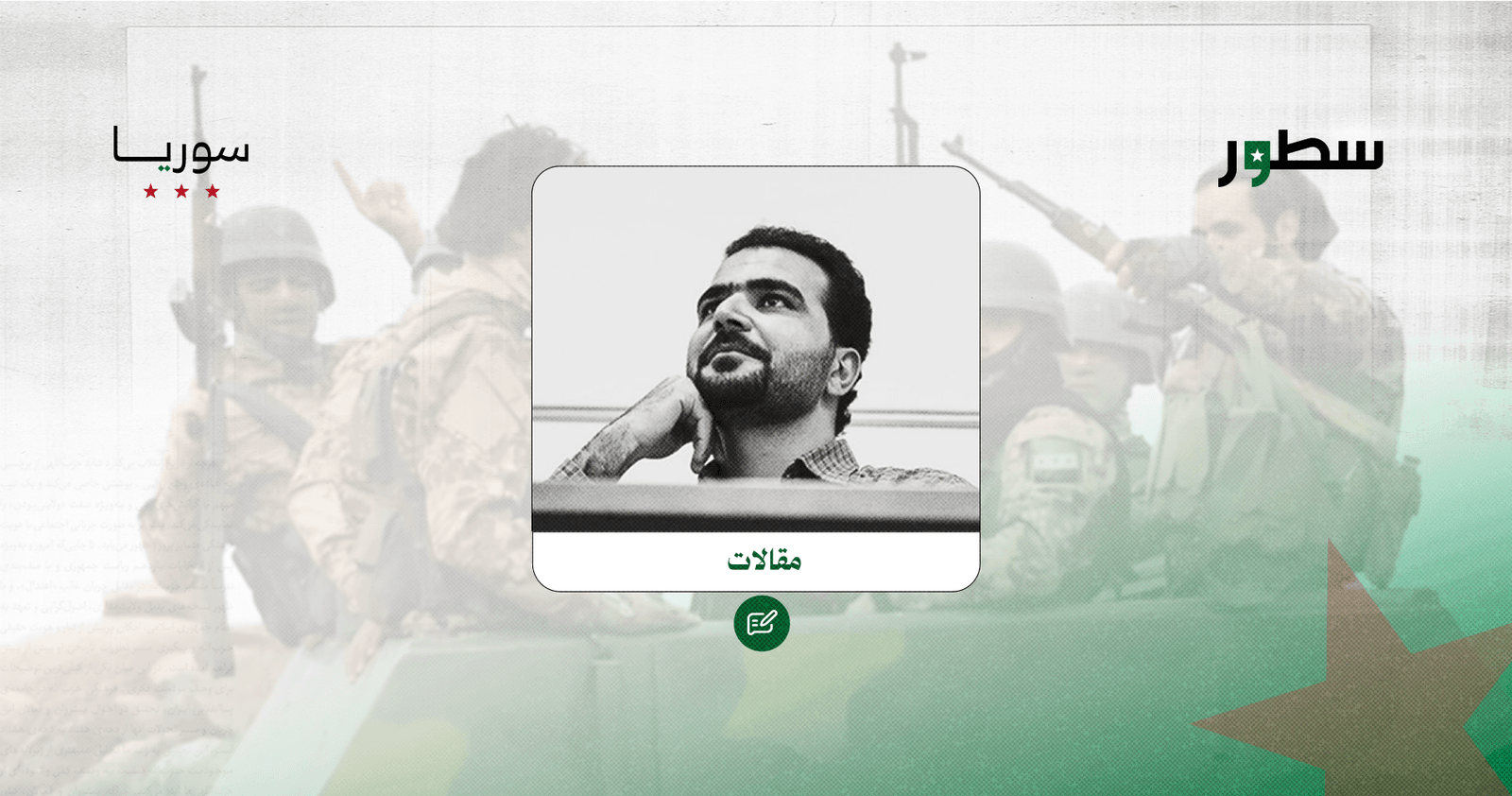مجتمع
السوري الفهلوي: عندما ترسم الجماهيرية مصيرنا
السوري الفهلوي: عندما ترسم الجماهيرية مصيرنا
موضوع أي ثقافة هو الإنسان كفردٍ متميز، أي بوصفه شخصية متفردة لا تتكرر، تتمحور حول وعيه الخاص وفرادته؛ أما الثقافة الجماهيرية، فمحورها ليس الفرد المتفرد، بل “الجمهور” أو “الإنسان الجماهيري”، أي الإنسان الذي تُلبى حاجاته بشكل جماعي ووفقاً لما هو شائع، دون عمق فكري. المفهوم الأخير «الجماهيري» قدمه المفكر الإسباني خوسيه أورتيغا إي غاسيت في كتابه الشهير “التمرد الجماهيري”. الكتاب الذي نُشر عام 1930. يشير هذا المفهوم إلى نوع جديد من الأفراد الذين ظهروا في المجتمعات الحديثة نتيجة التحولات الهائلة للثورات الصناعية والتقنية والديموغرافية.
يذوب الإنسان الجماهيري في الجماعة المحيطة به، ويصبح مجرد جزء من كتلة بشرية غير متميز، ولا واعٍ، ولا متفكر في مصيره أو حاله بعمق وتدبر. يرتجل الحياة والسياسة والإعلام، فالتخطيط والتفكير هو تنظير لا لزوم له. بدلاً من ذلك، ينزع إلى الامتثال والطاعة، ويفضل السير مع التيار والالتزام بما هو شائع دون تفكير نقدي، بل ويهاجم كل من تسول له نفسه الاعتراض أو التشكيك أو النقد. الثورة التقنية الهائلة، المتمثلة بوسائل التواصل الاجتماعي، عوّمت الجماهيري، بل تبدو أنها فُصلت على قياسه، وبالضبط حسب صفاته ومناقبه.
يتميز الجماهيري بالسطحية الثقافية ويفتقر إلى العمق الفكري، يكتفي بالمعارف السطحية التي تقدمها وسائل الإعلام. وكذلك نستطيع أن نضيف إلى هذا الإعلام المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في زمننا الحالي، الذين أصبحوا جزءاً من هذه المنظومة. هو لا يتساءل، ولا تشغله الألغاز والمجهول، فكل شيء بالنسبة له واضح وجلي. يعتبر الإجابات المؤدلجة التي تقدمها هذه الوسائل وهؤلاء المؤثرين دليلاً مطلقاً على صحة وجهة نظره التي لا يمكن أن تشوبها شائبة. تراه يشاركها على صفحته الشخصية، يضعها في التعليقات على منشورات المخالفين في وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على صحة رأي الجمهور، الذي يمثل بطبيعة الحال وجهة نظره.
التمرد غير الواعي هو من صفات الإنسان الجماهيري. هو يرفض الواقع الحالي، فيما لا يعير التفكير بالبدائل أي أهمية. إنه يرفض القيم والتقاليد القديمة دون تقديم بدائل حقيقية أو أصيلة. يثور في وجه نظام قائم دون أن يحسم ذلك الصراع الداخلي الذي يتمثل بالسؤال: إلى أين؟ سؤال متعب ومرهق، ويحتاج إلى بحث ومقارنات ومقاربات أبعد من منشورات الفيسبوك وتغريدات التويتر. بحث داخلي جواني يعمل العقل، والبحث أشد أعداء الإنسان الجماهيري، لذلك ينزع إلى التعلل بالظواهر الخارجية، ويراها دليلاً على أن الأوضاع بخير، والقافلة تسير في الطريق الصحيح، وكل نقد أو تفكر بحالها هو بالضرورة نباح مزعج لسمع الجماهيري.
يتطلع الجماهيري إلى المساواة المطلقة، يطالب بالمساواة دون اعتبار للفروق الفردية في الكفاءة أو الجهد. صوته أصبح مسموعاً بفضل الثورة التقنية، والتي جعلته يشعر أن كل ما يقوله هو الصواب بذاته، دون اعتبار لصحة رأيه أو عدمه. إنه موجود، فهو يفكر جيداً، وبشكل صحيح بالتأكيد، وهو قادر، وكامل، وذو أهمية. لذلك تراه شديد الثقة بنفسه وبرأيه، ولا تجد طريقة لثنيه أو طيه، أو أخذ القارب منه أو تجاوزه للعبور إلى الضفة الأخرى. إنه يجبر المخالف على العودة من حيث جاء، بكل هدوء.
ظهر الإنسان الجماهيري في بدايات القرن العشرين، نتيجة لتحولات اجتماعية واقتصادية كبرى مثل ازدياد التحضر والنزوح من الريف إلى المدن، وانتشار التعليم العام دون تعميق فكري. تعليم مدرسي كان أساساً قد نشأ في إنكلترا لتدريب طبقة بيروقراطية للإمبراطورية البريطانية، ولأن غايته الأساسية تنحصر في هذا المضمار، فإن التعليم العام، سواء في المدرسة أو الجامعة، يعطي جزئيات معرفية دون عمق ثقافي جواني داخلي. يُضاف إليها حديثاً عزل الناس في صناديق محدودة معرفية تُسمى التخصصات، تجعل الإنسان محدود الثقافة ومحشوراً في زاوية تقنية واحدة، في وضعية تدفعه دفعاً ليكون إنساناً جماهيرياً في الوعي السياسي وحتى الديني، الأمران اللذان يحتاجان إلى إلمام بمواضيع وهموم عدة.
الجماهيري السوري كان جزءاً من تركيبة نظام الأسد الثقافية والاجتماعية كانوا يصفون أنفسهم بأنهم أنصاف مثقفين يذبون عن الأسد ونظامه فيكملون بهذا الوظيفة النصف الآخر منها، وكان في صفوف الثورة عليه، وهو الآن يدخل نسيج الدولة القادمة من أوسع باب «عدم الثقة في النخب الفكرية القديمة» وثقة الجماهيري الفطرية بقدراته الفكرية تسمح له بالتفكير بلعب دور النخب الجديدة، توفر له «التريندات» على وسائل التواصل الاجتماعي، مادة مغرية لعرض قدراته الجماهيرية وحتى صنع جمهور خاص به، ويستهلك تلك الجماهيرية العلنية المؤيدة للسلطة، في محاولة لعب دور النخب القديمة الجماهيرية منها وغير الجماهيرية، السلطة الجديدة نفسها تجد مشكلة في الإنسان الجماهيرية و تحاول جاهدة تطعيم المشهد ببعض القائمين على الثقافة المتفردة وإسباغ شرعية على هذا المشهد من خلالهم.
عند حدوث تحولات ضخمة في المجتمعات، يسيطر الجماهيري دون جهد ودون منازع قوي، ويصبح الصوت الجماهيري هو الحاسم في القرارات السياسية والاجتماعية. على أثر هذا الانقلاب في المجتمع تنهار النخب الفكرية، حيث تُهمّش النخبة المثقفة، ويُستبدل رأيها برأي الأغلبية غير المثقفة، وهو ما يستدعي بالضرورة تراجعاً ثقافياً، ويسبب نزوعاً نحو التبسيط والتسطيح في الفكر والفن والأدب.
ويُضاف إلى ذلك، من وجهة نظر إي غاسيت آنذاك، التأثير القوي لوسائل الإعلام الجماهيرية، والتي اجتمعت في قرننا الحالي هذا مع وسائل التواصل الاجتماعي وقوة الوصول للمتلقي بتوفر الإنترنت، مما جعلها تؤدي وظيفتها الأساسية، وهي إقناع الإنسان بالفاعلية وإيهامه بقدرته على التعبير والمشاركة في صنع القرار، فيما تحقق هي الغاية الوحيدة لها، سواء كان ذلك عن قصد أو عن عدمه. هذه الغاية هي «السلبية»؛ سلبية الإنسان الجمهور المتفرج على الأحداث والتريندات، سلبية على مستوى الوعي، والانقياد خلف الآراء السائدة على مستوى التفكير.
مع تزايد ظاهرة الإنسان الجماهيري في المجتمعات المعاصرة، يمكن ملاحظة عدة تأثيرات سلبية على النسيج الاجتماعي والثقافي. منها تراجع جودة الخطاب العام، فمع هيمنة الأصوات الجماهيرية، أصبح الخطاب العام أكثر سطحية، ويعتمد على الشعارات بدلاً من التحليل العميق. وهنا تصعد الشعبوية، حيث يجد الخطاب الشعبوي أرضاً خصبة بين الجماهير، حيث تروج الأفكار البسيطة والشعارات التي تستجيب للمشاعر بدلاً من المنطق، وهو ما نراه حالياً بصعود ترامب للسلطة في الولايات المتحدة، وتقدم الشعبويين الأوروبيين في الانتخابات العامة في بلدانهم في السنوات الماضية، وهو ما نراه في سوريا اليوم على مستوى الخطاب الإعلامي الذي يتسم بالشعبوية الجارفة، مما يجعل سوريا الجماهيرية تأخذ مكانها في وسط الجماهيرية العالمية.
يتراجع الذوق الثقافي والفني في المجتمعات المهيمن عليها من قبل الإنسان الجماهيري، حيث يميل الأخير نحو الاستهلاك الثقافي السريع مثل البرامج الترفيهية والمنتجات الرائجة، على حساب الأعمال الفنية الراقية. وهو ما أصبح داءً عالمياً مع سرعة محتوى الإنترنت، والتي تتوازى مع الموضة السريعة التي أصبحت تحدد طريقة المظهر واللباس بشكل موسمي وسريع واعتباطي تقريباً، لا يراعي رأي المستهلك نفسه. وهنا تتلاقى المجتمعات الجماهيرية الهشة مع تمدد وتغول العولمة الاقتصادية والثقافية، لتكون هذه المجتمعات الهشة ثقافياً فريسة سهلة لحركة العولمة الهائلة.
في ظل الجماهيرية، تتراجع القيم الفكرية والنقدية. يصبح الحوار الفكري غير ذي أهمية، لصالح القبول الجماعي بما هو شائع ومألوف، حتى وإن كان خاطئاً أو غير أخلاقي. تنتشر ثقافة الإلغاء وتُعمم في المجال العام، حيث يُقصى كل من يختلف مع الرأي الجماهيري العام، دون مساحة للنقاش أو التفهم، تفشي هذه الثقافة أصبح واضح في الحالة السورية، الإلغاء من جميع الأطراف تقريباً حتى من يعتقدون أنهم أبعد ما يكون عنها ممن يعيشون خارج البلاد، حيث توفر لهم مجانية وحرية التعبير عن الرأي في بلاد المهجر، بيئة خصبة للجماهيرية التي تستتر وراء حرية التعبير، ليصبح هذا المفهوم هو الوجه البراني الخارجي الوحيد للثقافة على حساب الثقافة العميقة، ويستهلكها أصحابها في مواجهة السلطة سياسياً مستفيدين من هفوات الجماهيري المؤيد، مما يجعل الجماهيرية السورية تصعد لأقصى درجاتها المتمثلة بـ«الفهلوية» الفاقعة.