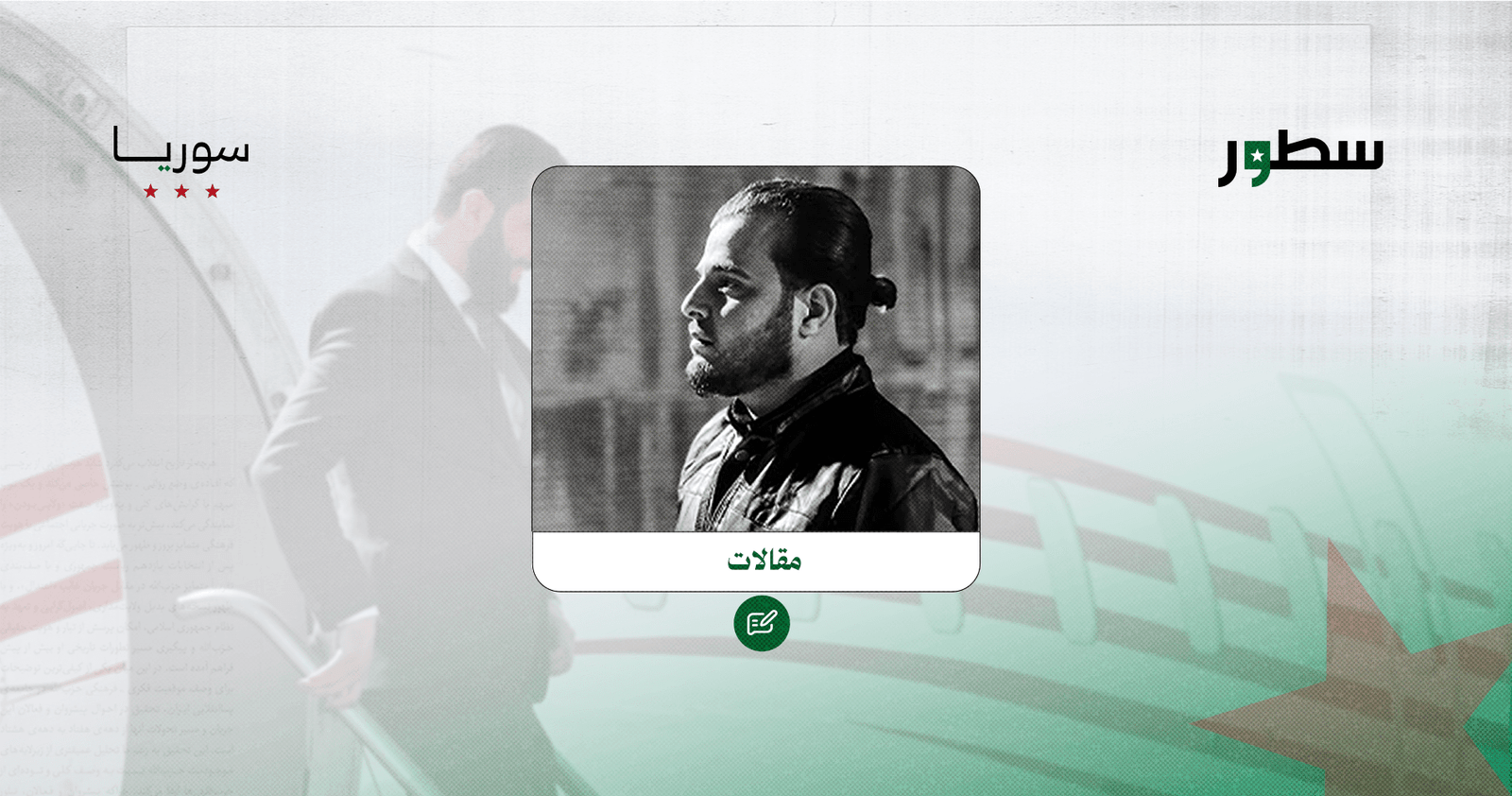ثقافة
تاريخ الشعر والبداوة: كيف شكلت الدولة الأموية الهوية السورية
تاريخ الشعر والبداوة: كيف شكلت الدولة الأموية الهوية السورية
الشعر العربي والبداوة هما العنصران الأساسيان اللذان يميزان الدولة الأموية. بهما قامت وبهما ازدهرت، وبهما سادت عصبية القبائل العربية وسيوف الفاتحين والتوسع العسكري في كل اتجاهات المعمورة. وإلى جانب ذلك الغزو السريع والواسع بفضل هذه العصبية، كانت الدولة الأموية دولة الثقافة الشعرية الشفهية، ودولة شعراء البلاط السلطاني مثل جرير والفرزدق وسواهم من كبار الشعراء العرب.
في زمن كان الشعر فيه أكثر من مجرد شعر، كان وسيلة إعلام ودعاية. كان الخلفاء والأمراء يبذلون الأموال في المديح، وكان الشعراء يقفون على أبوابهم لأخذ الأعطيات. كان الشعر رائجاً، الناس يتناقلونه ويحفظونه. ولم يكن يقتصر على الشعراء أنفسهم كما هو الحال في زمننا الحالي، حيث أصبحوا طائفة منعزلة تكتب لنفسها. بل إن يزيد بن معاوية الخليفة الثاني نفسه كان شاعراً فحلاً، حسب ما روى لنا التاريخ عنه. ورغم أنه نشأ في عائلة مكية تقيم في دمشق، إلا أن والدته ميسون بنت بحدل كانت بدوية شديدة الاعتزاز، لا تطيق العيش في الدور والقصور، وتفضل العيش في خيمة خارج الدار لتقيم فيها.
معاوية نفسه قال عن الشعر العربي: “اجعلوا الشعر أكبر همكم، وأكثر دأبكم، فيه مآثر أجدادكم ومواضع إرشادكم”، في إشارة إلى حقبة تاريخ العرب قبل الإسلام التي كان الشعر أهم تجلياتها الثقافية وكذلك مدونة تاريخية واجتماعية لحياتهم في البادية.
تزاوج ما بين الفصاحة والشعر والبداوة والانعتاق من المدنية وفروضها وتمسك بقيم البداوة، مما لا شك فيه أن العرب في الحقبة الأموية كانوا يحتقرون الحياة المدنية في البلاد المفتوحة حديثاً. فالمهنة في لسان العرب قادمة من الامتهان أو المهانة. وكذلك لم يكونوا مزارعين أو فلاحين، بل كانوا فرساناً مترفعين عن العمل في الحقول والمزارع. وحتى وقت قريب، كانت قبائل البدو توسم من يعمل في المهن من أبناء المدن بالصانع أو ابن الصانع. كان العرب آنذاك فرساناً يبغون المكانة والجاه، ويأخذون حقوقهم بيدهم وبسيوفهم.
وفر لهم الإرث البيزنطي والفارسي في الهلال الخصيب طبقة من الحرفيين والمعماريين تغنيهم عن القيام مباشرة بأعمال البناء والصناعة التي كانوا يحتقرونها بأنفسهم. وقد تصرفوا إلى الغزو والشعر، أبرز تجليين للحياة البدوية، مما أتاح لهم أن يواصلوا القتال على جبهات مختلفة، وأن يعنوا بالعمران وتشييد المباني في فترات استتباب الاستقرار القصيرة كما في عهد الوليد الأول.
هذه التركيبة جعلت من تسعين سنة هي عمر الدولة الأموية بشقيها السفياني والمرواني، عبارة عن احترابات داخلية وخارجية لم تنتهِ إلا بزوال هذه الدولة. كانت جلبة سلاح ووقعقعة محاربين، جيوش تجهز وجيوش تغادر، حركة عسكرية لم تهدأ ولم تتباطأ إلا بسقوطها الدموي والعنيف على أيدي خليط من الناقمين عليها. هؤلاء الذين تضرروا من فتوحها ومن جورها السياسي، لم يخفوا ولعهم بالانتقام من خلفاء أهل الشام وكل من يمت لهم بصلة.
الانتقام أتى على بني أمية، وطال كل من يواليهم من قبائل، على شكل موجات امتدت من عهد السفاح القصير إلى عهد المنصور، أبرز مؤسسي ومهندسي العنف العباسي لاحقاً. لم تنهار الإمبراطورية البدوية العربية الأولى والأخيرة جراء ضعف عسكري ناجم عن دخول المجتمع العربي الحاضن لها في حالة تنعم بمظاهر الحضارة، بل بسبب صراعات القبائل العربية فيما بينها. الصراع الذي بدأ مع قيام الدولة، واستفادت منه العائلة الحاكمة في اللعب على التوازن بين القيسية واليمانية. وفيما كان هذا الصراع إيجابياً في مقتبل الدولة، إلا أنه أصبح وبالاً في عهد الخلفاء الضعفاء، حيث أدت السياسات التمييزية في تولية الإمارات والمناصب، وتبدلها من فترة خليفة إلى آخر، إلى انفضاض العرب عن الدولة، مما ساهم في سقوطها بعدما أصبحت لعبة الولاءات والمحاصصة مكشوفة ومبتذلة.
خلال تلك التسعين سنة، لم يُدون أي كتاب. كل ما نعرفه عن الأمويين كتبه أعداؤهم العباسيون أو في عهدهم. ورغم أن التوسع الجغرافي كان سمة الدولة الأموية حتى بلغت الصين في مشرق الأرض وفرنسا في مغربها، إلا أن العصور الذهبية للحضارة الإسلامية كانت في عهد بني عمومتهم العباسيين. نشأت المذاهب الإسلامية، ودُوِّن الشعر الجاهلي، ووضعت قواعد اللغة العربية، وظهرت علوم الكلام والصرف والعروض.
لم تكن دولة العباسيين مهتمة بالتوسع العسكري ولا بالغزو، ربما لأن مادتها الرئيسية كانت من الفرس. أما القبائل العربية فقد قامت مع الأمويين وزالت سطوتها بزوالهم. الدولة البدوية الشعرية الفريدة لم يعد مسموحاً لعربي أن يتطاول في عهد بني العباس. التفاخر بالنسب أصبح حقاً حصرياً للعائلة العباسية فقط، الهاشمية القرشية. اعتمدوا على الفرس ثم على الأتراك عندما بدأت الشكوك في ولاء المكون الفارسي تنخر العائلة العباسية. أما قبائل العرب فلم تكن ذات حظوة كبيرة فيها.
التاريخ الأسطوري الذي يروى حالياً عن بني أمية والدولة التي أقاموها، يقابله التاريخ الاجتماعي للشعوب التي حُكمت والتي حكمت والتي غُلبت والتي غلبت على السواء. نستمر في تدريس تاريخ الملوك والسلاطين وننسى تاريخ الناس العاديين، الطبيعيين، أو العامة أو السوقة، هؤلاء الذين لا محل لهم في هذا التاريخ. أناس مثلنا، نحن الأكثرية من المجتمع، بشر عاديون لا يذكرون في معلقات ولا تخط أسماءهم في كتب التاريخ.
يبدو إرجاع هذا التاريخ إلى مربع الإنسان الذي يخطئ ويصيب، يكره ويطمع، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أمراً بعيد المنال في الوقت الراهن. لقد أرهقنا من جراء إعادة كتابة التاريخ بما يناسب الإرادة السياسية والمزاج الشعبي. اجتزاء فترة تاريخية لاستخدامها دعائياً وإعلامياً قد تكون له نتائج مدمرة على المدى الطويل.
دراسة التاريخ لكي نتحرر من التاريخ، بأن نستخلص العبر والدروس بكل شفافية، لا أن نسجن في تاريخ أسطوري “سوبرماني” أبطاله أشخاص بلا مشاعر، بلا أخطاء، بلا هفوات. نخترع لهم دائماً تبريرات بأثر رجعي حتى نثبت أن من المستحيل أن يخطئوا. نصورهم كشخصيات معلقة في الفراغ، بدون مشاعر وبدون ضعف إنساني، شخصيات تاريخية صماء، ممنوع الاقتراب منها أو نقدها.
أو العكس، شيطنة فترة تاريخية وجعلها حضيضاً يجتمع فيها كل ما هو سيء ومنحط. الأمر يبدأ من المدرسة ويمر من بوابة الدراما التلفزيونية التي قدمت خلال فترة حكم الأسد، وفي ذروة استشعاره بالخطر بعد الغزو الأمريكي في العراق، عدة أعمال درامية تاريخية سعت للإضاءة على الحقبة الأموية ومركزية سوريا في الوعي العروبي. تحولت بشكل مقصود أو غير مقصود من أعمال درامية فيها تفاصيل كثيرة وضعاً لضرورة فنية إلى مسلمات تاريخية، رغم أن ما رشح إلينا من تاريخ هذه الفترة قليل وإشكالي.
الذات الدور الذي أدته المسلسلات التاريخية التركية في تصدير صورة تاريخية غير حقيقية عن الدولة العثمانية، صورة رسمها المخرجون وكتاب السيناريوهات، في وقت كانت هذه مهمة الباحثين والمؤرخين. هؤلاء انزاحوا جانباً مع إغراء الصورة الدرامية وسهولة فهمها، وتلاعبها بمشاعر المتلقي.
لم يكن التغني ببني أمية ودولتهم مع السلطة الجديدة القائمة في سوريا مجرد تمجيد، بل بدأه النظام الأسد في عهدي الأب والابن. لم يأخذ هذا الطابع الشعبي الكاسح في التمجيد والتسامي على كل ما هو غير سوري، ولكنه وظف سياسياً ذلك التاريخ القصير من عمر سوريا الإسلامية. فالدولة الأموية كانت قصيرة جداً لم تناهز تسعين عاماً من تاريخ عمره 1400 عام من عمر الإسلام. فترة وجيزة، ورغم بعض الشواهد العمرانية كالجامع الأموي وبعض القصور في بادية الأردن وفلسطين، لم تكن هناك إنجازات عمرانية تذكر. تطور فيها التمدد العسكري السريع ممتزجاً بالثقافة الشفوية، فيما يبدو استكمالاً للحقبة الجاهلية بتجلياتها الاثنين: الغزو والشعر. ولكنها لم تكن لتجاري الحقبة العباسية مثلاً، الدولة التي قامت على الدعوة الدينية.
الجذور التاريخية لذلك التوظيف تنحدر من نهايات الدولة العثمانية. ركز فيها القوميون العرب جهودهم لإيجاد قومي بديل للسلطنة. ظهرت جمعيات قومية في سوريا والعراق عظمت الرموز العربية، وصلت ذروتها مع وصول الأمير فيصل إلى دمشق عام 1918. ومع اتخاذ شعار عقاب خالد بن الوليد، والتي كانت راية قريش، رمزاً للدولة السورية وما زال مستمراً حتى اللحظة.