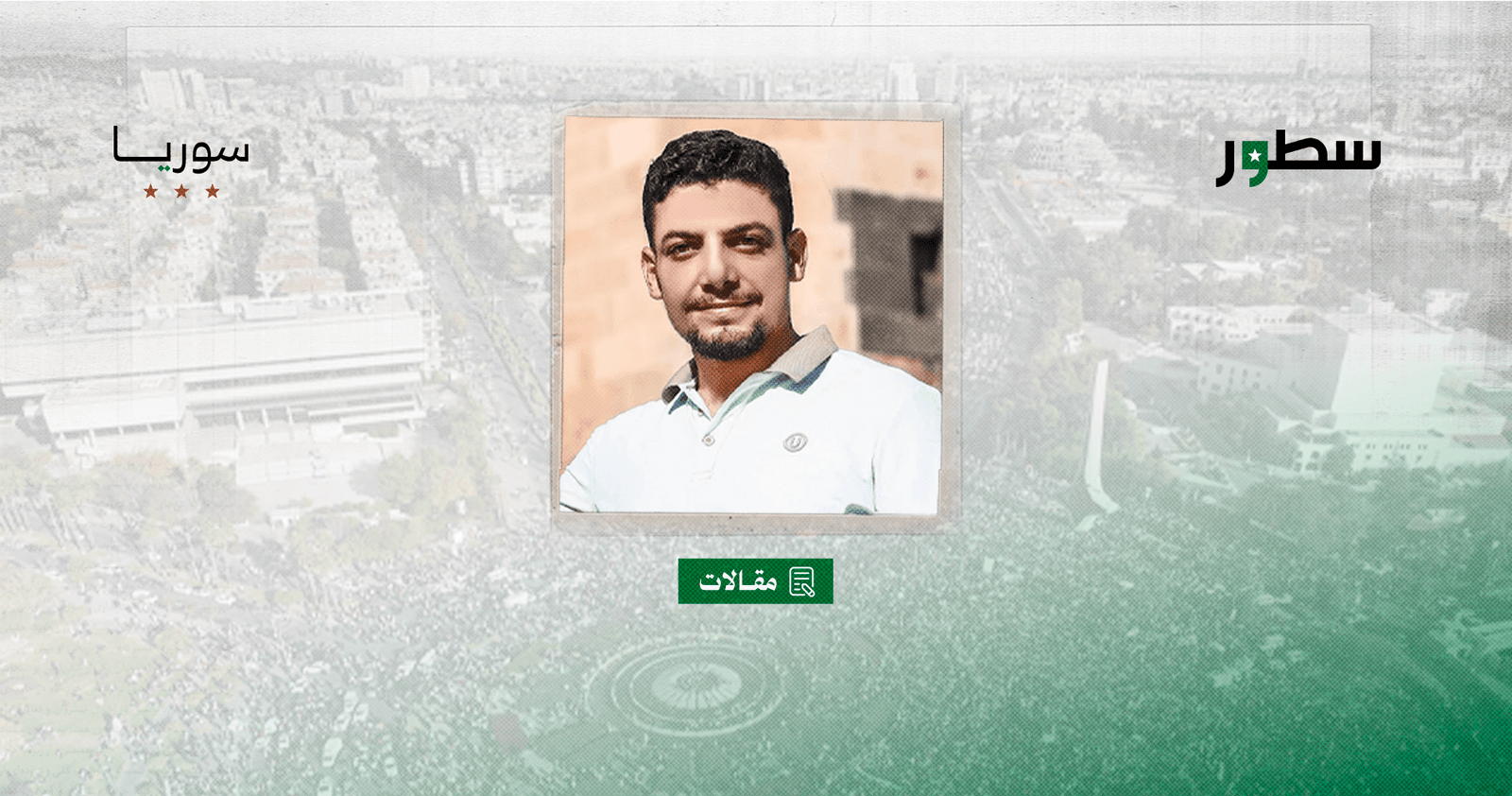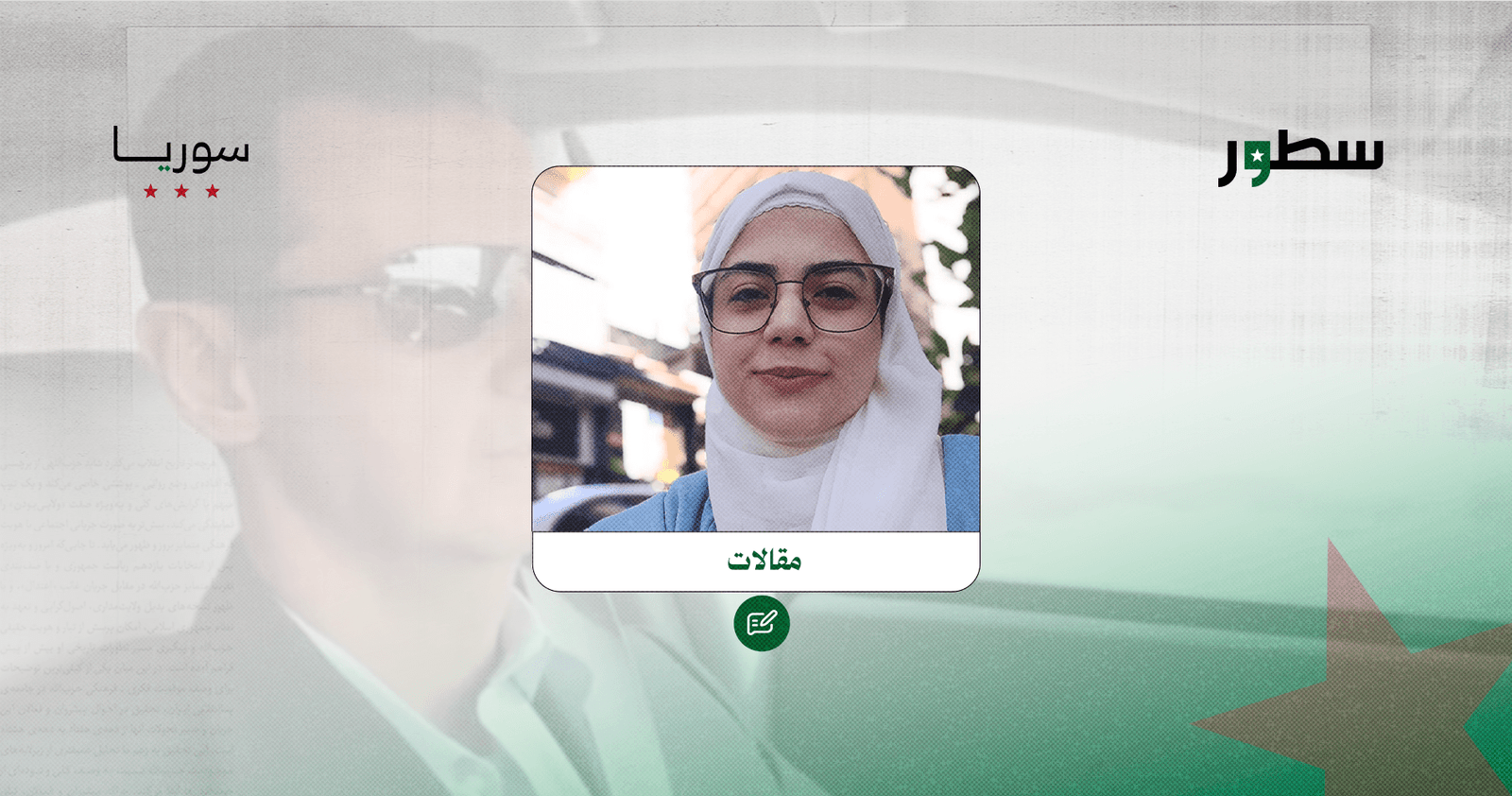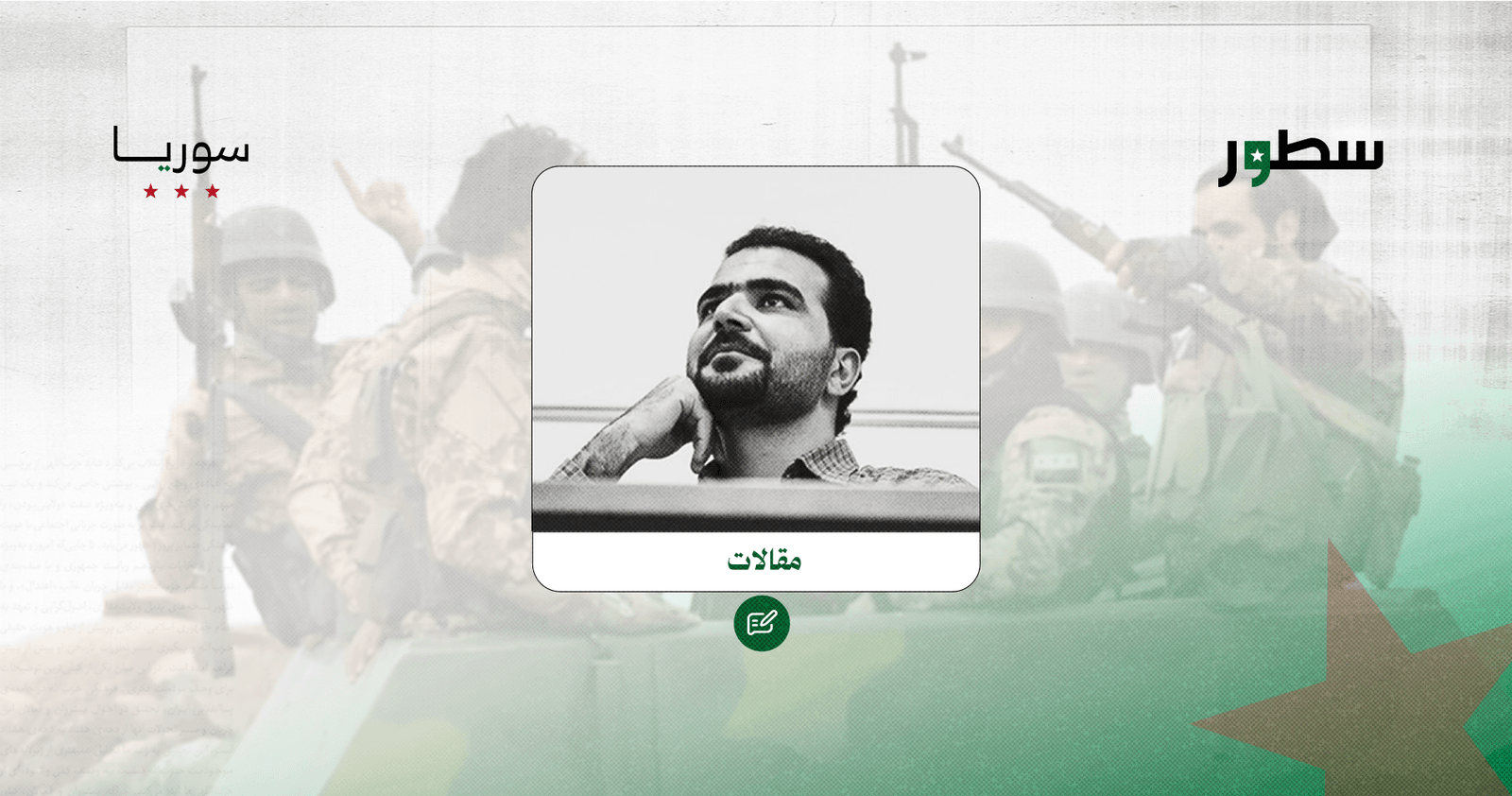مجتمع
هجرة العقول السورية: من القمع إلى الإبداع في المنافي
هجرة العقول السورية: من القمع إلى الإبداع في المنافي
– منيرة الشغري
تعيش سوريا منذ عقود أزمة حقيقية في استثمار طاقاتها البشرية، تجلّت في ظاهرة مستمرة من هجرة العقول والكفاءات، التي تسارعت بعد اندلاع الثورة عام 2011. لم تكن هذه الهجرة مجرّد نتيجة للحرب، بل امتداداً لسياسات ممنهجة من القمع والتهميش.
فبينما كان العالم يُشيد مختبرات لعلمائه، كانت سوريا تُشيد ملفات أمنية لمبدعيها.
وفي المقابل، برزت الكفاءات السورية في المنافي، محرزةً إنجازات لافتة في ميادين العلم والعمل، مما يثبت أن المشكلة لم تكن في العقول، بل في مناخ الاستبداد الذي كبّلها؛ إذ لم يكن الشباب السوري يوماً أقل شأناً من غيره، ولا أقل قدرة على الإبداع والتقدّم.
هذه المقالة تسعى إلى تفكيك أسباب هجرة العقول السورية، منذ بدايات حكم الأسد الأب وحتى ما بعد الثورة، كما تبحث في سبل الاستفادة من الكفاءات السورية المهاجرة، بوصفها ركيزة أساسية في مستقبل البلاد.
أولاً: قمع الطاقات الشابة في ظل النظام السوري
منذ سبعينيات القرن الماضي، اتّبع النظام السوري نهجاً صارماً في التعامل مع الطاقات الشبابية. أُغلقت أبواب المبادرة، وتحوّلت مؤسسات الدولة إلى فضاءات بيروقراطية ميتة، لا تتسع لأي فكرة خارجة عن المألوف.
بلغ هذا القمع ذروته في أحداث الثمانينيات، حين شنّ النظام بقيادة حافظ الأسد حملات اعتقال جماعي استهدفت الآلاف من الشبان، لا سيما النخب الجامعية وأصحاب التوجهات الفكرية المستقلة.
زرع النظام في وعي جيل كامل أن الطموح خطر، وأن التفكير الحر قد يكون تذكرةً إلى المقصلة.
ورغم مرور العقود، بقي أثر تلك المرحلة حاضراً؛ إذ نشأ الأبناء على تركة الخوف، وورث الشباب شعوراً عميقاً بأن الإبداع يقود إلى المحاسبة، لا إلى التقدير.
في عهد الابن، استمرت المنظومة القمعية واتخذت أشكالاً أكثر تعقيداً؛ إذ لم يقتصر التقييد على الوسائل الأمنية المباشرة، بل توسّع ليشمل أشكالاً من القمع النفسي.
ثانياً: التعليم كأداة تقييد لا تحفيز
شكّل النظام التعليمي في سوريا عاملاً آخر في تقييد القدرات. فبدل أن يكون أداة لاكتشاف المواهب وتوسيع المدارك، تحوّل إلى منظومة تلقين جامدة لا تحترم الفروق الفردية، ولا تتيح مساحة للطالب كي يسأل أو يجتهد.
ولم تقتصر المشكلات على البنية والمحتوى، بل تجاوزتها إلى العدالة التعليمية؛ إذ سادت ثقافة المحسوبيات والولاءات، خاصة في مراحل الدراسات العليا.
فغالباً ما كانت المقاعد تُمنح وفقاً للانتماء السياسي أو الاجتماعي، لا للجدارة الأكاديمية، مما دفع بالكثير من المتميزين إلى الإحباط أو الهجرة.
ثالثاً: تفوّق المغتربين السوريين في الخارج
مع بدء موجات الهجرة الكثيفة بعد عام 2011، تبيّن حجم الظلم الذي كانت تعانيه هذه الطاقات داخل البلاد. ففي الجامعات الأوروبية وكبرى المؤسسات البحثية، ظهر تفوّق الطلاب السوريين بشكل لافت مقارنة بجنسيات أخرى.
هذا التفوّق لم يكن وليد الحظ، بل نتاج صراع طويل من التحديات.
أما الذين لم يهاجروا، فغرقوا في دوامة السعي لتأمين أبسط مقوّمات الحياة، وعجزوا عن توجيه طاقاتهم إلى أي إنجاز علمي أو إبداعي، نتيجة انهيار البنية التحتية وانعدام الأمل.
رابعاً: الأرقام تتحدث – هجرة العقول قبل الثورة وبعدها
وفقاً لتقارير معهد بحوث العمالة الألماني (IZA) والبنك الدولي، فإن سوريا كانت منذ الثمانينيات واحدة من أكثر الدول العربية التي تعاني من هجرة الكفاءات.
لكن ما بعد عام 2011 شهد قفزة نوعية؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 50% من الكفاءات الشابة غادرت البلاد في العقد الأول من الثورة، لا سيما من القطاعات الطبية والهندسية والبحثية.
بالمقابل، بقي الداخل السوري يعاني من نقص حاد في المتخصصين، وتدهورت جودة التعليم والصحة والخدمات بشكل غير مسبوق.
خامساً: سبل الاستفادة من الكفاءات المهاجرة
رغم قسوة الفقد، لا تزال هناك فرص حقيقية للاستفادة من العقول السورية المهاجرة، سواء اختارت العودة أو فضّلت البقاء في الخارج.
فيما يلي بعض المقترحات العملية:
- منصات إلكترونية: تجمع الكفاءات السورية وتنسّق بينها بحيث تتيح تقديم استشارات علمية، تدريبية أو مهنية للطلاب والمهنيين داخل سوريا.
- شراكات بحثية بين الجامعات السورية ومراكز البحوث العلمية بواسطة الباحثين السوريين المغتربين.
- دعم اقتصادي واستثماري لمشاريع ناشئة داخل البلاد.
- بناء قواعد بيانات للخبرات: جمع وتوثيق الكفاءات السورية عالمياً وتنظيمها ضمن قواعد بيانات لتسهيل التعاون المهني والعلمي.
الاستثمار في العقول السورية المهاجرة ليس خياراً إضافياً، بل ضرورة وجودية في مسار بناء المستقبل.