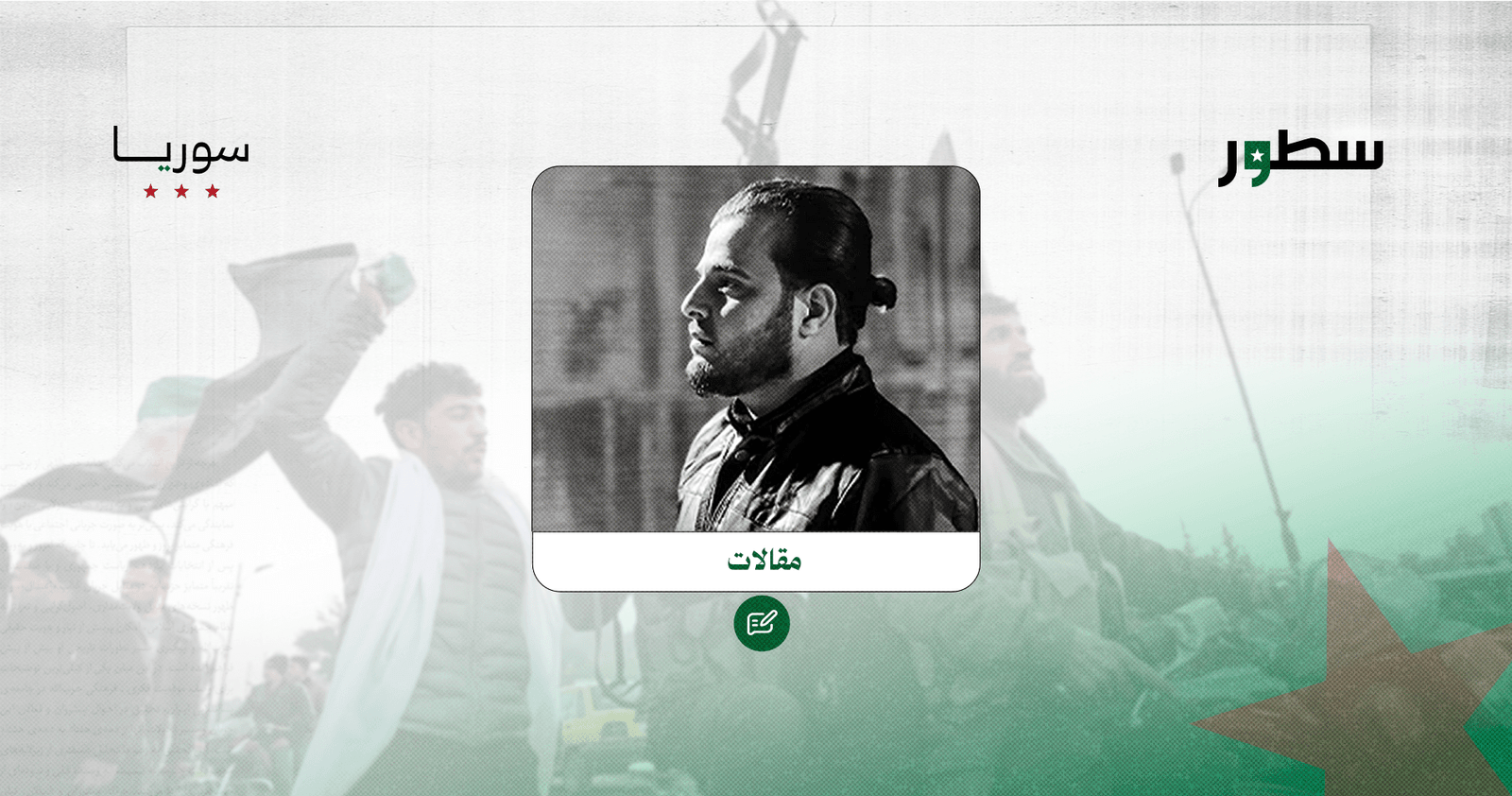سياسة
أحداث صحنايا وجرمانا: الصدام الذي نزل من ساحة الكرامة
أحداث صحنايا وجرمانا: الصدام الذي نزل من ساحة الكرامة
لفهم الأحداث الدموية المؤسفة الأخيرة في جنوب دمشق، وبالذات في ضاحيتي جرمانا وصحنايا، اللتين تقطنهما أغلبية من المكون الدرزي، وكانت مزيجًا من تحريض طائفي وصراع سياسي بين أطراف سورية قلقة من المستقبل المجهول لسوريا، لا بد أن نعود إلى تاريخ العلاقة بين جبل العرب وسلطة دمشق. الجبل الذي يبدو دائمًا في موقع المعارض في وجه السلطة المركزية، يمنح قاطنيه حماية جغرافية واضحة، ويختزن تاريخًا من الخلافات السياسية والمناطقية والطائفية مع المركز.
كان جبل العرب في صدام مع الفرنسيين بعد أن قبضوا على زمام الأمور في دمشق، ومن قبلهم كانت العلاقة يسودها الشك وانعدام الثقة بين الأهالي والسلطنة العثمانية. أثناء الحكم العثماني، دخل الدروز في صدام طويل مع القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا لما يقارب السبع سنوات، رافضين إلحاقهم بالسلطة المركزية التابعة لمحمد علي باشا. فبينما بدا حكم سوريا سهلًا لمحمد علي، كما هو الحال في مصر، اصطدم برفض الطوائف المتعددة وأبرزهم الدروز، الذين شكلوا حجر الزاوية في تعطيل أحلامه.
لقد جعل وعورة الجبل وتكاتف مجتمعه من التغلغل فيه أمرًا صعبًا على الدولة، ورفضوا التجنيد الإجباري الذي فُرض عليهم. لدى أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، حساسية شديدة من تدخل السلطة في شؤونهم الداخلية.
في أحداث 1860 الطائفية في بلاد الشام، وقع الصدام مع طوائف أخرى في لبنان وسوريا، وسط توجس من التمدد الأوروبي الذي فرضته الثورة الصناعية وسهله مسيحيو المشرق عبر الحصول على الوكالات التجارية الغربية. أُثري بعض أبناء بلاد الشام بينما أُفقِر آخرون، ووجد الدروز أنفسهم في صراع لا مفر منه أمام تغوّل جيرانهم من جهة البحر. امتدت الأحداث من لبنان إلى دمشق، وتدخلت الدولة العثمانية بقوة، فأعدمت المحرضين على الفتنة من المسلمين ونفت مئات من الدروز، في محاولة لتجميل صورتها أمام الغرب وهي ترزح تحت وطأة الضعف والتدهور.
اليوم، تُتناوَل قضية السويداء ببعد طائفي من قبل شريحة شعبوية تسيطر على الشارع السني أو تسايره، مع التركيز على الدعم الإسرائيلي العلني لبعض التيارات داخل الأقلية الدرزية. ويُتجاهل السياق التاريخي للصراع بين الجبل وسلطة دمشق، أيًّا كانت هذه السلطة وتوجهاتها، وهو صراع تفرضه الجغرافيا والسياسة. فالجبل كان دائمًا ملاذًا للمعارضين، التجأ إليه عبد الرحمن الشهبندر وساسة آخرون في عهد الانتداب الفرنسي، ولاذت به وجوه معارضة في أواخر حكم الأسد.
علاقة الجبل بالمركز معقدة للغاية، تتراوح بين الانكفاء والتحالف مع الممتعضين من الحكم، أو مسالمة السلطة. لكن هناك ما لا يقبل به سكان الجبل مطلقًا، وهو تغلغل السلطة المركزية فيه حتى يصبح قرارهم بيدها. التمايز الناعم عن المحيط وعن مركز السلطة هو جوهر الأيديولوجيا السياسية للجبل تاريخيًا، ودائمًا هناك مسافة تفصل بين الطرفين، تطول أو تقصر.
مع بداية الربيع العربي، أخذوا مسافة من نظام الأسد. لم يدعموه، ولم يثوروا عليه. المسافة نفسها بقيت مع قوى الثورة: لا مشاركة في القمع، ولا في الصدام. ومع السلطة الحالية، تطمح بعض القيادات الدرزية إلى إعادة الدور التاريخي للجبل، لا اندماجًا كاملاً يعادل اعترافًا بها، ولا مواجهةً تامة.
بعد الاستقلال، وجدت حكومة القوتلي صعوبة بالغة في إخضاع الجبل. ومن طرائف التاريخ أن الحكومة دعمت انتفاضة شعبية ضد بيت الأطرش، أمراء الجبل الإقطاعيين، تحت شعارات العدالة في توزيع الأراضي. كان هذا مثاليًا لدمشق لبسط نفوذها. لكن تدخلها أدى إلى فشل الحراك، وقيل إن قوات الدرك مع وزير الداخلية كانت تنتظر على مشارف السويداء للتدخل. فما كان من الدروز إلا أن التفوا حول سلطان باشا الأطرش، الذي عقد مجلس حرب وانتصر، فعادت قوات الدرك إلى دمشق وتركوا الجبل لأهله.
لم تسعَ دمشق بعد ذلك إلى فرض سلطتها المركزية بالقوة. وخلال الانقلابين الأوليين، بقيت الأمور على حالها. لكن انقلاب العقيد أديب الشيشكلي شكّل فارقًا، فهو كان ديكتاتورًا شابًا متحمسًا لحكم الفرد، لكن لم تكن الظروف مهيأة لهيمنة العسكر التامة. لم يكن الجيش السوري مؤهلًا بعد لابتلاع الدولة، وهو ما تم لاحقًا بعد سنوات، حين تولى حافظ الأسد السلطة.
حينها، سُحب الجبل إلى صراع مع سلطة الشيشكلي، فالمعارضة لم تجد بدًّا من الاحتماء به، وأهل الجبل فرّوا من تنامي العسكرة وتآكل الديمقراطية. أحداث 1954 لم تكن طائفية بالكامل، بل انفجرت في غفلة ضمن سياق سياسي، ويقال إن البعثيين أطلقوا إشاعة عن انتفاضة قادمة من جبل العرب، ما أثار ردة فعل عنيفة من السلطة، التي نشرت قواتها في السويداء. هذا الانتشار غير المعتاد أثار ذعر الأهالي، وتحوّلت حوادث فردية إلى صدامات دموية، انتهت بسقوط الشيشكلي بعد انضمام حلب إلى العصيان.
حافظ جبل العرب على استقلاله النسبي، وأدار نفسه بالاعتماد على السلطة الروحية لمشايخ العقل واحترام العادات. حقيقة أن للجبل وضعًا خاصًا إداريًا أمر مُسلم به في كل الحقب التاريخية. والمرة الوحيدة التي فُرض عليه حل خارجي كانت في الثورة السورية الكبرى، التي انتهت بلجوء سلطان باشا الأطرش إلى المملكة العربية السعودية، لكنه عاد بعد تسوية زعيمًا وحيدًا، إذ رفض الأهالي أي صيغة من الانتداب لا تتضمن زعامته.
الضغط الذي تمارسه السلطة الحالية في دمشق لإقصاء بعض القيادات الدرزية وتحجيمها، سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز شعبيتها محليًا، وربما تجد السلطة نفسها في مواجهة مع كل الجبل. التعامل مع ملف السويداء يتطلب صبرًا ودبلوماسية ومفاوضات طويلة وشاقة، والعودة إلى المربع الأول: الاعتراف الضمني بالوضع الخاص للجبل، الذي تفرضه الجغرافيا والسياسة والخصوصية الثقافية.
نحن متمسكون بوحدة الأراضي السورية، لكننا ندعو السلطة الجديدة إلى فهم أعمق للمكونات السورية. وهو أمر يتطلب مراكز أبحاث وقرارات سياسية نابعة من وعي اجتماعي واقتصادي حقيقي، لا قرارات ارتجالية لا تفرز سوى مزيد من التوتر. المطلوب بناء اتفاق بطيء، لا اتفاق سريع ينقلب عليه الطرفان في اليوم التالي.
إن الأحداث الأخيرة وُلدت من ساحة الكرامة. وإذا كنا لا ننكر السلوك الصدامي لبعض أجنحة السلطة، فإننا نرى أن التماهي الكامل لأهل الجبل مع صورة ساحة الكرامة كـ”بوصلة الحل في سوريا” قد يضخم من شعورهم بالدور التاريخي المنوط بهم. نعم، نحن نثمن الغيرة الوطنية، لكننا نعتقد أن مشاكل سوريا تحتاج إلى مشاركة سورية واسعة، وتعافيها لا يكون بحمل مكون واحد لهمّ البلاد، فذلك قد يؤدي إلى تضحيات بلا جدوى.
إن أي جهد محلي أو مناطقي يحتاج إلى تلاقٍ مع صوت آخر من الطرف المقابل، وإلا فسيبقى صوتًا بلا صدى.