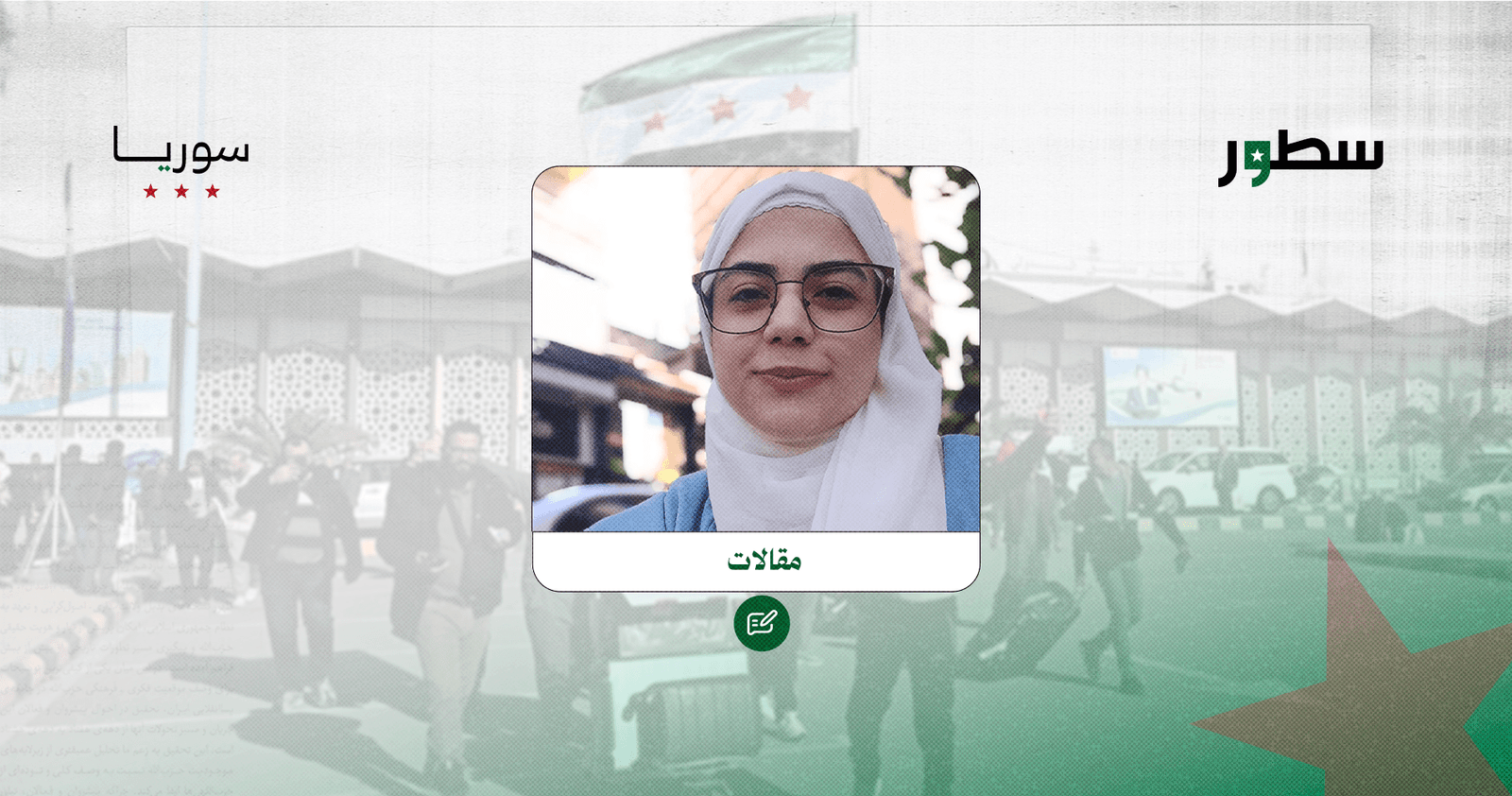سياسة
صدمة التغيير: الإسلاميون والأكراد السوريون بين الحلم والواقع
صدمة التغيير: الإسلاميون والأكراد السوريون بين الحلم والواقع
بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الثاني من العام الماضي، أصبح أصحاب المشاريع الطوباوية في أزمة حقيقية؛ فالتحرير وجّه نظر السوريين من جميع التوجهات صوب إعادة الدولة السورية إلى وضع ما قبل 2011، بحدودها ووضعها القانوني القديم، مدعومًا بتوجه دولي يصب في ذات المصب، فلا تغيير في خرائط الشرق الأوسط، ولا قبول دولي للفكرة أساسًا، مما جعل هذه المشاريع وأصحابها في مهب ريح التغيير.
هذا التغيير المفاجئ في سوريا أربك دعاة المشاريع غير الواقعية، خصوصًا مع خلط الأوراق خارجيًا وداخليًا، فجأة وبدون سابق إنذار، بعد أن ظن عموم السوريين بانسداد الأفق أمام حل سياسي. ينهار النظام بشكل سريع، فاسحًا المجال أمام “هيئة تحرير الشام”، التي اعتنقت تغيّرات فكرية مخالفة لمرتكزات الحركات الجهادية، وبدا أن جناحًا منها على الأقل وجّه وجهه نحو دولة مدنية، أو على أقل تقدير، محافظة اجتماعيًا وسياسيًا ولكنها مقبولة دوليًا وإقليميًا.
مجرد أن هذا التغيير ـ الذي لا يُستهان به حقيقة، رغم التشكيك في دواعيه ـ حصل في ذهنية هذه الحركة الجهادية العتيدة، القوية شعبيًا وتنظيميًا، والمستندة إلى إرث المؤسسين للفكر الجهادي العالمي، يطرح كثيرًا من إشارات الاستفهام حول حقيقة القدرة على تنفيذ فكرة دولة الخلافة أو تحكيم الشريعة الإسلامية. فهل هي فكرة طوباوية أثبتت أربعة عشر عامًا من الثورة والعمل المسلح للإسلاميين في سوريا ضد النظام وضد التيارات السياسية الأخرى، عقمها وعدم واقعيتها؟ حتى قيّض لهؤلاء الجهاديين أن يتغيّروا ويتبدّلوا تحت ضغط الواقعية السياسية.
إن جمهور الإسلاميين في سوريا وأنصارهم لم يكن ليقبل بأي حديث عن مدنية الدولة أو صناديق الاقتراع إذا طرحه أي تيار سياسي آخر، ولكنهم يقبلون ذلك من قائد إسلامي هو أحمد الشرع.
إن تبنّي جناح في هيئة تحرير الشام لتغيّرات واقعية وديناميكية تواكب التغيّرات السياسية العميقة في المنطقة والعالم، سيكون وقعُه أشدّ مضاضةً على نفوس الجناح الآخر من متبني أفكار إقامة الشريعة والخلافة الإسلامية، من التغيّرات نفسها. فهو يكاد يكون نعيًا لأفكارهم ونسفًا لإمكانية تحقيقها.
فالإخوة والمشايخ الذين هم في قمة هرمَي السلطة في سوريا والهيئة على السواء، قد بدأوا في التماهي مع أفكار التعايش مع المختلف، والذي بالضرورة سوف يُحيل إلى تغيّرات فكرية ونفسية في التعامل معه، مما يجعلهم يبتعدون عن أفكار كوادر الهيئة في الوسط والقاعدة.
كل تلك الحسابات تولّد شعورًا لدى الطرف المقابل من الهيئة بأنه محاصر ومقصى ومُبعَد، يستجر وحيدًا أفكاره الطوباوية ويتحسر على فرصة ضائعة لتحقيقها، وربما لاعنًا يوم سقوط النظام؛ ذلك اليوم الذي فتح باب التغيير عريضًا في داخل الهيئة، مخرجًا إياها من نموذج إدلب الصافي إلى نموذج سوريا الممزوج بالشوائب الفكرية والعقائدية.
على الجانب الآخر من طوباوية “هيئة تحرير الشام”، تبدو طوباوية الحركات الكردية شديدة القلق تجاه المستقبل. ففكرة الدولة الكردية، التي دفع الأكراد ثمنًا باهظًا من أجلها، تبدو في أكثر أوقاتها بُعدًا عن التحقيق. وفيما كان طوباويو الأكراد يعزون ذلك إلى أنظمة قومية عروبية في سوريا والعراق، يتفاجأ مناصروهم بأن هناك عائقًا آخر أكثر صعوبة، وهو النظام الدولي نفسه.
فالنظام العالمي الذي خرج إلى الحياة بعد الحرب العالمية الثانية، ويتبناه حُرّاسه من الدول الكبرى والمؤثرة فيه، يتّبع سياسة عدم التغيير، خصوصًا فيما يخصّ المشاكل الترابية بين الدول. فالحدود التي رُسمت خلال فترة التأسيس تبدو “مقدسة” في نظرهم، وأي تساهل في التهام دول كبرى لدول أصغر، أو تفكيك دول إلى كيانات إثنية أو دينية، يبدو ضربًا من المستحيل بوجودهم، مع القدرات العسكرية والاقتصادية الضخمة التي تجعل من أي محاولة لتحديهم نوعًا من الانتحار.
لدينا أمثلة كثيرة: حالة العراق والكويت في حرب الخليج الثانية، والتي استدعت ردًا دوليًا دمّر العراق بشكل مأساوي، وفشل تجربة جنوب السودان، الذي انقسم بدوره إلى تيارات تطالب بتقسيم المُقسَّم، وأفضت إلى اقتتال داخلي. وهو ما كان السبب الرئيسي لتقسيم السودان على أمل إيقاف النزاعات الإثنية والدينية. وتجربة الحرب الأوكرانية التي عزلت روسيا وقوضت نفوذها الدولي، وجعلت من الرئيس الروسي مطلوبًا لمحكمة الجنايات الدولية، بالرغم من حجم روسيا كدولة وقوة استراتيجية.
بقدر ما تكون فكرة الدولة الكردية صعبة التحقيق لعوامل شتى، منها: عدم وجود منفذ بحري، ومجتمع دولي غير مرحّب بتغيّرات على الخارطة السياسية في الشرق الأوسط، وقد بدا ذلك واضحًا من خلال الرفض الدولي للاستفتاء على الاستقلال الذي قام به الإقليم الكردي العراقي قبل عدة سنوات، إضافة إلى عدم توفر اتفاق سياسي بين المكونات الكردية نفسها، تبدو فكرة دولة قومية تسير في عكس اتجاه التاريخ.
خصوصًا مع وجود أمثلة لأنظمة قامت على أساس قومي في المنطقة، مثل نظامي البعث في العراق وسوريا، واللذين لم يقدّما أي مكاسب حقيقية للعرب أنفسهم، بل على العكس، فقد جلبا الويل والدمار للعرب في هذين البلدين. لقد حكموا باسم العروبة، ولكن العرب أنفسهم عانوا تحت حكمهم. قد يأتي من يحكم باسم الأكراد وباسم كوردستان، وقد يكون أشدّ وبالًا على الأكراد من أنظمة المنطقة نفسها.
عودة إلى ما سبق، يحق لنا التساؤل حقًا عن المكاسب التي سوف تقدمها دولة الشريعة للشعب المسلم فيها، فالأنظمة العربية جميعها هي أنظمة محافظة، تبني المساجد، وتموّل التعليم الديني، ولم نشاهد حتى اللحظة قمعًا ممنهجًا للتدين في المجتمع، أو محاولة لشطب الدين من الحياة العامة. إن صراع الأنظمة العربية، بشكل عام، مع تيارات الإسلاميين، مبعثه سياسي، ولا يتعلق بحرية التدين أو قمع مظاهر الدين في المجتمع السوري.
مؤخرًا، تصاعد الحديث عن اتجاه تخريبي في صفوف “هيئة تحرير الشام”، والذي ربما يتلاقى لاحقًا مع الاتجاه التخريبي المهيمن والأساسي لتنظيم الدولة الإسلامية، والذي يكثر الحديث عن خطره في سوريا في وسائل الإعلام العالمية والمحلية.
والأمر قد ينسحب أيضًا على موقف “قوات سوريا الديمقراطية”، فالتغيرات الفكرية التي قامت بها تحت مسمى “وحدة الشعوب”، وإشراك المكون العربي في شرق سوريا في العمل العسكري والسياسي، تحت ضغوط دولية وإقليمية معروفة، جعلت من الحديث عن دولة كردية أثرًا بعد عين. فكل هذه التغيرات التدريجية، التي تواكب رغبات الحلفاء والمخاوف من غائلة الجيران الذين لا يخفون عداءهم، أفرغت فكرة “كوردستان الكبرى” التي ينادي بها “حزب العمال الكردستاني”، الأب الروحي لقوات سوريا الديمقراطية، من محتواها، وبقيت شكلًا بلا مضمون حقيقي.
وحقّ للإنسان الكردي أن يتساءل عن جدواها، وجدوى السير في ركابها. ومن حقّنا أن نتوقع اتجاهًا تخريبيًا مضادًا للتيار الكردي، الذي يحاول التقرب من دمشق، ويرى أن الواقعية السياسية تفرض حلًا تحت مظلة الدولة السورية، مكتفيًا بحقوق ثقافية، وتنمية اقتصادية، ومشاركة سياسية في صنع القرار، على نمط التجربة الكردية العراقية في إقليم شمال العراق.
إن العامل المُهمَل عمومًا في صفوف متبني الأفكار الطوباوية هو الإنسان، الذي يبدو بالنسبة لهم مجرد حطب يُرمى في محرقة الفكرة الطوباوية. فالإنسان لا قيمة له في نظرهم كإنسان، خارج نطاق هذه الفكرة. لذلك يعاني أعداء الفكرة وجمهورها على السواء.
ولدينا أمثلة كثيرة على أفكار طوباوية حملت في ثناياها وحشيةً بالغة، ودمويةً مسرفة، وانتهت كفقاعة، رغم كل التضحيات والمصائب.
ربما في زمن قادم، تختفي الحاجة إلى الطوبى في العمل السياسي في الشرق الأوسط، أو تنزوي في مكانها الطبيعي، كتعبير عن اليأس والإحباط وغياب التنمية، يمكن تطويقها، وألا تكون تيارًا شعبيًا جارفًا يُنهي بجريانه أي نمو إنساني وحضاري صغير، ولكنه واقعي وحقيقي في مجتمعات المنطقة.